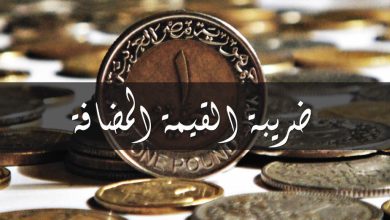حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة


حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة
هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنة بين الزكاة، كما شرعها الإسلام، وبين الضريبة الوضعية، كما تمخضت عنها الأفكار والأنظمة المالية الحديثة. فنحن لا نقارن الزكاة بالضرائب، في عصر الرومان أو الفُرس، وفي العصور الوسطى بأوروبا؛ إذ لا مجال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب في تلك العصور، وإنما نقارن الزكاة بالضريبة في صورتها الحديثة بعد أن مرّت بتطورات شتَّى، وأدخلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة، وصقلتها تجارب القرون، وخدمتها عقول كبيرة من مختلف الأقطار والبيئات، حتى نضجت واستوت على سوقها.
وسنبين في فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضريبة الحديثة من مشابهات ومقارنات، تتجلى بها حقيقة كل منهما، وتتميز بها الزكاة بوصفها فريضة مالية ذات طابع خاص، وفلسفة خاصة. فهي متميزة في طبيعتها وأساسها، ومواردها ومصارفها، وأنصبتها ومقاديرها، كما هي بمبادئها وأهدافها وضماناتها، وسنرى كيف سبقت بثلاثة عشر قرنًا -أو تزيد- أرقى ما انتهى إليه الفكر المالي والضريبي في عصرنا الحديث من مبادئ وأحكام، وكيف امتازت بمعان تقصر عنها الضريبة.الضريبة كما عرَّفها علماء المالية: فريضة إلزامية. يلتزم الممول بأدائها إلي الدولة، تبعًا لمقدرته علي الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة من ناحية، وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسة وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى (من كتاب مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد إبراهيم: 1/261، وقد استخلص هذا التعريف بعد محاولة تكييف طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها).
والزكاة – كما عرفها فقهاء الشريعة – حق مقدر فرضه الله في أموال المسلمين لمن سماهم في كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، شكرًا لنعمته تعالى، وتقربًا إليه، وتزكية للنفس والمال.
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة
ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف، وأوجه اتفاق بين الضريبة والزكاة، وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق.
( أ ) فعنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به، موجود في الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع الإيمان، ومقتضى الإسلام، وأي قسر وإلزام أكثر من أخذها بقوة السلاح ممن منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا شوكة؟.
( ب ) كما أن من شأن الضريبة أن تدفع إلي هيئة عامة مثل السلطة المركزية والسلطات المحلية (إنما ذكروا هذا القيد في معنى الضريبة، احترازًا مما كان يحدث في أوروبا في العصور الوسطى عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلي صاحب الأرض!)، وكذلك الزكاة، إذ الأصل فيها أن تدفع إلي الحكومة بواسطة الجهاز الذي سماه القرآن “العاملين عليها” كما وضحنا ذلك في موضعه.
( ج ) ومن مقومات الضريبة: انعدام المقابل الخاص، فالممول يدفع الضريبة بصفته عضوًا في مجتمع خاص، يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة، والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص وإنما يدفعها بوصفه عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحمايته وكفالته وأخوته. فعليه أن يسهم في معونة أبنائه، وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة، وأن يقوم بواجبه في إقامة المصالح العامة للأمة المسلمة التي بها تعلو كلمة الله وتنشر دعوة الحق في الأرض، بغض النظر عما يعود عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة.
( د ) وإذا كان للضريبة -في الاتجاه الحديث- أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة فوق هدفها المالي فإن الزكاة لها أيضًا أهداف أبعد مدىً، وأوسع أفقًا، وأعمق جذورًا، في هذه النواحي المذكورة وفي غيرها، مما له الأثر في حياة الفرد والجماعة (انظر ذلك بتفصيل في باب “أهداف الزكاة” من هذا الكتاب).
أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة
تلك هي أوجه الاتفاق.
فأما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة، فهي كثيرة، نذكرها أو أهمها في الأمور التالية:
1- في الاسم والعنوان:
إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة الأولى في الاسم والعنوان لكل منهما وما له من دلالة وإيحاء.
فكلمة “الزكاة” تدل في اللغة على الطهارة والنماء والبركة، يقال: زكت نفسه، إذا طهرت، وزكاة الزرع، إذا نما وزكت البقعة، إذا بورك فيها.
واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بها عن الحصة التي فرض إخراجها من المال للفقراء وسائر المصارف الشرعية – له في النفس إيحاء جميل، يخالف ما توحي به كلمة “الضريبة”.
فإن “الضريبة” لفظة مشتقة من ضرب عليه الغرامة أو الخراج أو الجزية ونحوها، أي ألزمه بها، وكلفه تحمل عبئها،ومنه: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة) (البقرة: 61)..
ومن هنا ينظر الناس عادة إلي الضريبة باعتبارها مغرمًا وإضرارًا ثقيلاً.
أما كلمة “الزكاة”، وما تحمله من دلالات التطهير والتنمية والبركة، فهي توحي بأن المال الذي يكنزه صاحبة، أو يستمتع به لنفسه، ولا يخرج منه حق الله الذي فرضه -يظل خبيثًا نجسًا، حتى تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح والبخل.
وهي توحي كذلك بأن هذا المال الذي ينقص، في الظاهر، لمن ينظر ببصره، يزكو وينمو ويزيد، في حقيقة الأمر، لمن يتأمل ببصيرته. كما قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (البقرة: 267).
(وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) (سبأ: 39)، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وما نقص مال من صدقة) (رواه الترمذي (في الزهد برقم (2326) من حديث أبي كبسة الأنماري وقال: حسن صحيح).
وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست للمال وحده، بل للإنسان أيضًا: لآخذ الزكاة ولمعطي الزكاة. فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر بها نفسه من الحسد والبغضاء وتنمو بها من معيشته، إذ تحقق له ولأسرته تمام الكفاية.
وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل وتزكو نفسه بالبذل والعطاء، ويبارك له في نفسه وأهله وماله، وفي القرآن الكريم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة: 103) .
2- في الماهية والوجهة:
ومن أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة: أن الزكاة عبادة فرضت على المسلم، شكرًا لله تعالى، وتقربًا إليه. أما الضريبة فهي التزام مدني محض خال من كل معنى للعبادة والقربة، ولهذا كانت “النية” شرطًا لأداء الزكاة وقبولها عند الله، إذ لا عبادة إلا بنية: ( إنما الأعمال بالنيات): (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) (البينة: 5).
ولهذا أيضا تذكر “الزكاة” في قسم “العبادات” في الفقه الإسلامي.
اقتداء بالقران والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة. فالقرآن في نيف وعشرين موضعًا من سوره المكية والمدنية، وأما السنة ففي مواضع لا حصر لها، كما في حديث جبريل المشهور، وحديث: (بني الإسلام على خمس) وغيرها. فكلاهما ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعبادة من عباداته الأربع.
ولما كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركنًا دينيًا من أركان الإسلام، لم تفرض إلا علي المسلمين، فلم تقبل الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة مالية فيها طابع العبادة والشريعة الدينية، وهذا بخلاف الضريبة، فهي تجب على المسلم وغير المسلم، تبعًا لمقدرته على الدفع.
3- في تحديد الأنصبة والمقادير:
والزكاة حق مقدر بتقدير الشارع، فهو الذي حدد الأنصبة لكل مال، وعفا عما دونها، وحدد المقادير الواجبة من الخمس إلي العشر، إلي نصف العشر، إلي ربع العشر. فليس لأحد أن يغير فيما نص عليه الشرع أو يبدل، ولا أن يزيد أو ينقص، ولهذا خطَّأنا المتهورين الذين نادوا بزيادة المقادير الواجبة في الزكاة، نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمخض عنها العصر الحديث (انظر: صفحة 266 – 268 من هذا الكتاب).
بخلاف الضريبة، فهي تخضع في وعائها، وفي أنصبتها، وفي سعرها، ومقاديرها – لاجتهاد السلطة وتقدير أولي الأمر، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها.
4- في الثبات والدوام:
يترتب على هذا: أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، لا يبطلها جور جائر، ولا عدل عادل، شأنها شأن الصلاة فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة الإسلام. أما الضريبة فليس لها صفة الثبات والدوام، لا في نوعها ولا في أنصبتها ولا في مقاديرها، ولكل حكومة أن تحور فيها وتعدل حسبما ترى، أو يرى أهل الحل والعقد من ورائها. بل بقاؤها نفسه -كما ذكرنا- غير مؤبد، فهي تجب حسب الحاجة وتزول بزوالها.
5- في المصرف:
وللزكاة مصارف خاصة، عينها الله في كتابه، وبينها رسوله -صلى الله عليه وسلم- بقوله وفعله، وهي مصارف محددة واضحة، يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها -أو على معظمها- زكاته بنفسه إذا لزم الأمر، وهي مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي. أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة.
ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، واجبة الصرف إلي الأبواب المنصوص عليها، والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها (فريضة من الله) (كما في الآية 60 من سورة التوبة).
6- في العلاقة بالسلطة:
ومن هذا يُعلم: أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبين السلطة الحاكمة، وهي التي تسنها، وهي التي تطالب بها، وهي التي تحدد النسبة الواجبة، وهي التي تملك أن تنقصها، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معين ولسبب خاص، أو على الدوام، بل تملك إلغاء ضريبة ما، أو الضرائب كلها إن شاءت. فإذا أهملت السلطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم علي المكلف، ولا يطلب منه شيء، أما الزكاة فهي -قبل كل اعتبار- علاقة بين المكلف وربه. هو الذي آتاه المال، وهو الذي كلفه أن يؤتي منه الزكاة، امتثالاً لأمره وابتغاء مرضاته، وعرفه مقاديرها، وبين له مصارفها.. فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تجمع الزكاة من أربابها، وتصرفها على مستحقيها، فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفريقها على أهلها ولا تسقط عنه بحال. مثلها في ذلك مثل الصلاة، لو كان المسلم في مكان لا يجد فيه مسجدًا ولا إمامًا يأتم به، وجب عليه أن يصلي حيث تيسر له، في بيته أو غيره، فالأرض كلها مسجد للمسلم ولا يترك الصلاة أبدًا، والزكاة أخت الصلاة.
ولذلك يجب علي المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب النفس بها، راجيًا أن يتقبلها الله منه ولا يردها عليه، ويستحب له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاء: (اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا).
ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة ولا يتهرب من دفعها، كما يتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب، فإن لم يتهربوا دفعوها مكرهين أو كارهين. بل نجد من المسلمين من يدفع من ماله أكثر مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند الله، وطلبًا لمثوبته ورضوانه. كما حدث ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيما بعده من العهود، وسنعود إلى بيان ذلك في فصل “الضمانات” بين الضريبة والزكاة.
7- في الأهداف والمقاصد:
وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أفق عال، تقصر الضريبة عن الارتقاء إليه، وقد أشرنا إلى هذه الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة “الزكاة” وما لها من دلالة وما تنطوي عليه من إيحاء، كما فصلنا الكلام عليها في باب “أهداف الزكاة وآثارها” (أنظر: ص 905 وما بعدها من هذا الكتاب)، وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح كتاب الله في شأن أصحاب المال المكلفين بالزكاة حيث قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم) (التوبة: 103)، ومعنى (صل عليهم) أي ادع لهم، وكان -صلى الله عليه وسلم- يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي ماله، وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمعطي الزكاة اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، بل قال بعض الفقهاء: هو واجب، لأن الآية أمرت به وظاهر الأمر الوجوب.
أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف، وقد ظل رجال المالية قرونًا يرفضون أن يكون للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة، وسمي هذا “مذهب الحياد الضريبي” فلما تطورت الأفكار، وتغيرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، انهزم مذهب الحياديين، وظهر الذين ينادون باستخدام الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، أو تقريب الفوارق وغير ذلك، وهذا إلى جوار هدفها المالي، وهو الهدف الأول.
ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالية العامة ومفكروها أن يخرجوا من دائرة الأهداف المادية، إلى دائرة أرحب وأبعد مدى، وهي دائرة الأهداف الروحية والخلقية التي عنيت بها فريضة الزكاة.
8- في الأساس النظري لفرض كل منهما:
ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة، هو الأساس الذي بني عليه فرض كل منهما. فالأساس القانوني لفرض الضريبة قد اختلف في تحديده على نظريات متباينة سنذكرها. أما الزكاة، فإن أساسها واضح، لأن موجبها هو الله عز وجل، وسنجليه في نظريات أربع، لا تعارض بينها، وإنما يشد بعضها أزر بعض، وقد آثرت أن أفرد لذلك فصلاً مستقلاً حتى أوفيه حقه إن شاء الله.
الزكاة عبادة وضريبة معًا
ومن هنا، نستطيع أن نقول: إن الزكاة ضريبة وعبادة معًا، هي ضريبة لأنها حق مالي معلوم تشرف عليه الدولة، وتأخذها كرهًا إن لم تؤد طوعًا، وتنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على المجتمع بالخير.
وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة. يتقرب بأدائها المسلم إلى الله، ويشعر حين يؤديها أنه يحقق ركنًا من أركان الإسلام، وشعبه من شعب الإيمان، وأنه يعين بها من يعطيه على طاعة الله تعالى، ومن هنا كان إيتاؤها طاعة وصلاحًا، ومنعها فسقًا صُراحًا، وجحودها كفرًا بواحًا، فهي حق الله الذي لا يسقط بتأخر الجابي، ولا بإهمال الحاكم، ولا بمرور السنين وليست كالضريبة: تجب بطلب الحكومة لها، وتسقط بعدمه
والذي يهمنا أن نذكره هنا: أن علماءنا رحمهم الله قد تنبهوا ونبهوا علي أن الزكاة تشتمل على هذين المعنيين: معنى الضريبة، ومعنى العبادة، وإن لم يعبروا عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه، لأنه اصطلاح متأخر، وقد يعبرون عن هذا المفهوم بأنها “حق” واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1 /237 – طبع مطبعة الاستقامة). أو يعبرون عنه بأنها “صلة للرحم” أي الإنسانية أو الإسلامية، بجانب ما فيها من شائبة العبادة.
ومن أوضح ما يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، ما نقله صاحب “الروض النضير” عن بعض المحققين من العلماء في بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال: “إنما فرض الله الزكاة في أموال الأغنياء، مواساة لإخوانهم الفقراء، قضاء لحق الأخوة وعملاً بما يوجب تأكيد الألفة، وما أمر الله به من المعونة والمعاضدة على ما فيها من ابتلاء أرباب الأموال، التي هي شقائق النفوس، كما ابتلاهم في الأبدان بالعبادات البدنية، فهي صلة للرحم، وفيها شائبة عبادة، فلأجل شائبة العبادة وجبت فيها النية، ولم يصح فيها مشاركة معصية، ونحو ذلك، لكونها صلة، صحت فيها الاستنابة، وصح فيها الإجبار عليها، وناب الإمام عن المالك في النية عند أخذها كرهًا، وأخذت من مال الميت وإن لم يوص، ولأجل كون الصلة غالبًا عليها، وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء، ووجبت في مال الصغير ونحوه، ولما كان المقصود بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا في مال خطير وهو النصاب، ولم يجعلها إلا في الأموال النامية، وهي العين (النقود) وأموال التجارة والمواشي وما أخرجت الأرض، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، ورتب مقدار الواجب على حسب التعب والمؤنة، فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشر، وفيما سقي بالسواقي (الدواب ونحوها) نصفه” (الروض النضير: 2/389). أ هـ، وهو كلام جيد فصلناه في الأبواب السابقة.